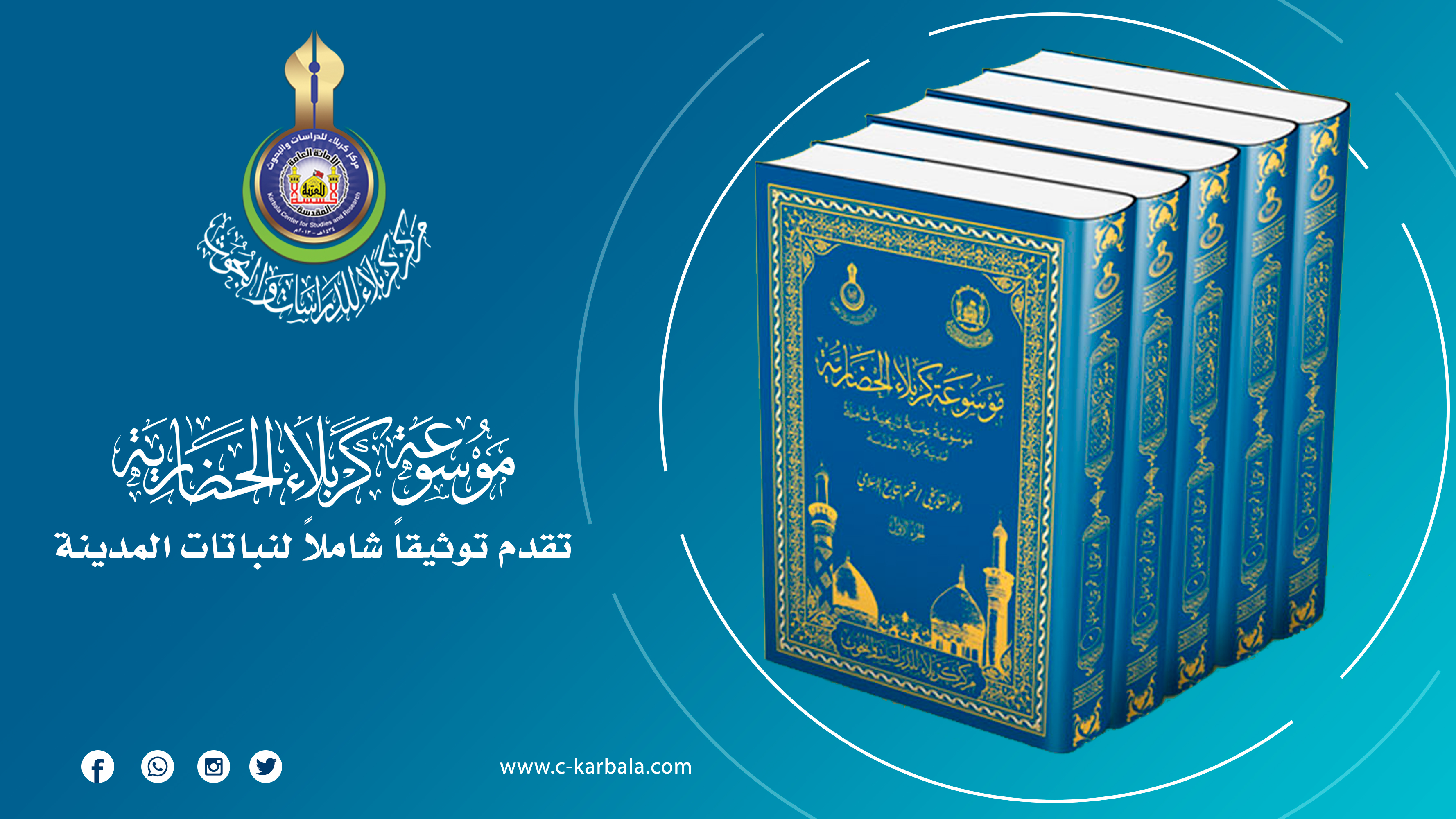تعدّت كربلاء كونها مدينة للقداسة والزيارة، لتكون موطناً غنياً بالتنوع النباتي الذي يعكس تمايز بيئاتها الجغرافية بين السهل الرسوبي والهضبة الصحراوية.
هذا التنوع الطبيعي قد منح المدينة بُعداً بيئياً واقتصادياً قلّ نظيره، وأدى دوراً محورياً في معادلة التوازن البيئي ومقاومة التصحر.
ففي قلب السهل الرسوبي بمحافظة كربلاء، تنمو نباتات ضفاف الأنهار مشكّلةً أحراشاً طبيعية تعانق ضفاف الفرات وتفرعاته، وهناك، تصطف أشجار مثل الصفصاف والغرب والأثل إلى جانب العوسج والحلفا والعاقول، في لوحة طبيعية متكاملة.
ووفقاً لموسوعة كربلاء الحضارية الصادرة عن مركز كربلاء للدراسات والبحوث، فإن هذه النباتات لا توفر الوقود وتسهم في تقليل العواصف الترابية فحسب، بل تسهم أيضاً في تحسين التربة ودعم الثروة الحيوانية عبر الرعي.
إلى جانب هذه النباتات البرية، زرع الإنسان منذ القدم أنواعاً مفيدة مثل السدر واليوكالبتوس، ممّا ساعد في تشكيل بيئة زراعية متوازنة.
أما نباتات الحقول والأراضي الزراعية، فتزدهر في الأراضي الرسوبية المحيطة بالفرات، وخاصةً على مدرجاته وفي أحواض الأنهار، حيث تنمو هناك أنواع شتوية وصيفية، حولية ومعمرة، أبرزها الشوفان البري، والشوك، والعاقول، والطرطيع، والعبيرة، والشويل، والتي تكمن أهميتها في دعم الرعي والزراعة وحتى مقاومة ملوحة التربة.
وفي الهضبة الغربية من كربلاء، تظهر النباتات الصحراوية كجنود مقاومة تقف بوجه الجفاف والتصحر، وتنقسم هذه النباتات إلى شجيرات معمّرة وحولية وأخرى من الحشائش والأعشاب، والتي ينتمي معظمها لعائلة الرمرامية، المعروفة بقدرتها على مقاومة الأملاح وشح المياه.
من أبرز هذه الأنواع هي الشيح، والسدر البري، والطرفة، والشنان، والرمث، والتي تزدهر صيفاً وخريفاً وتغذي قطعان الماشية حينما تختفي الأعشاب الموسمية.
أما الحشائش والأعشاب الصحراوية النابتة في كربلاء، فتنقسم إلى معمّرة مثل الحرمل والكملان، وأخرى حولية مثل الكتب والزعتر، حيث تُستخدم في بعض الأحيان لأغراض علاجية وشعبية.
تجدر الإشارة إلى أن كربلاء تمثل بيئةً متنوعة تُجسّد تمازجاً فريداً بين النهر والصحراء، وتُعدّ دراسة نباتاتها خطوة أساسية نحو التنمية البيئية المستدامة ومواجهة تحديات التصحر والتغير المناخي، مما يستدعي جهوداً بحثية وخططاً زراعية تحافظ على هذا الإرث الطبيعي الثمين.
المصدر: مركز كربلاء للدراسات والبحوث، موسوعة كربلاء الحضارية الشَامِلَةُ، المحور الجغرافي، 2017، ج1، ص89-91.